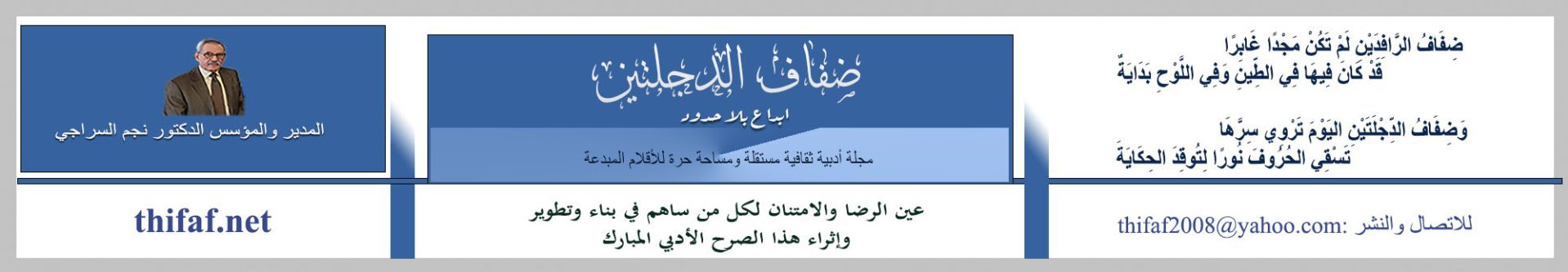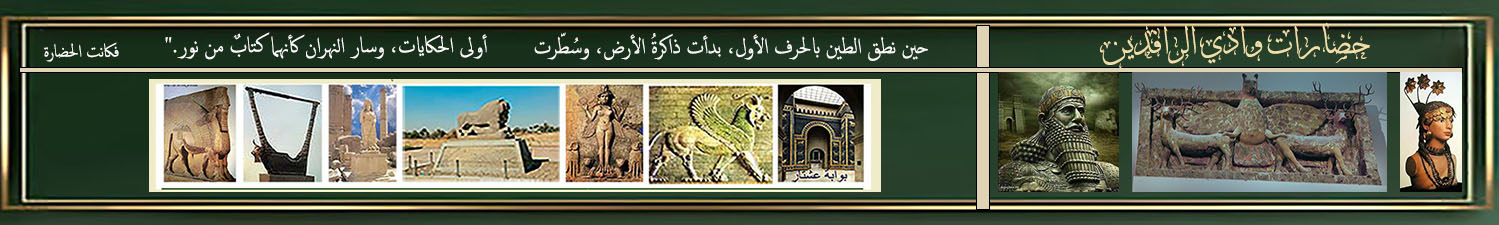جاسم عاصي
التماثل في مجال الأساطير و العقائد .
جاسم عاصي
jassimasee@yahoo. com
———————————————————————-
تتناول هذه الدراسة شأن من شؤون التأثر والتأثير الحضاري , الذي هو فعالية إنسانية تلقى حراكا ً وتبادلا ً في المجال الثقافي الحيوي كالفكر والدين , وجملة الطقوس والفعاليات المثيولوجية , التي تبنتها البشرية على أنها تؤشر الرؤية الأساسية للكون والوجود . لذا فإن أمر التأثر والتأثير , حالة من الحالات الكبيرة التي تقلل المسافات وتلغي الأزمنة وتقرب الأمكنة . فالعنصر البشري مجبول بالتغيير والتبديل , ومن ثم بالاستشراف لما هو مناسب لطبيعة الحراك الحاصل في الواقع . إنه نوع من السعي لعقد الانسجام والتوافق , وهذه المظان هي بالأساس موروثات تتفاعـل مع بعضها من خلال النقل والحاجة إلى تشكل المعارف والبنى . وفي هذا لابد من وجود اعتبارات مفادها أن لا تتحول هذه الفعاليات المعرفية إلى تشكيل نوع من الحيازات , بحيث يظهر من خلالها نوع من الضغط على المعنى أو الكينونة ا لغـرض منه إثبات أحقية انتسابها قسرا ً إلى هذا العصر أو ذاك , أو إلى هذه الجماعة أو تلك , فالتفاعـل مشروط , والانتحال مرفوض . إن التبادل الثقافي , ينتظم كل الأشكال والعقائد والأفكار والفلسفات من أجل إثبات حقيقة مطلقة , وهي جدلية المثاقفة , وجدلية الترحيل . ذلك لأن حقيقة المتحرك الإنساني عبر التأريخ يتخذ له متقابلات , نطلق عليها ــ التناصـّات ــ . فالأقوام والجماعات والشعـوب تتأثر ببعضها من باب تأسيس مفاهيم الحياة . وما ا لطقوس التي أ استنبتت منذ بدء الخليقة , إلا ّمحاولة لإعادة التوازن للكون والعلاقات البشرية . من هذا فستكون قراءتنا للبنى المشكلة للوجود الثقافي هو من باب التوالي التاريخي للثقافة الإنسانية . وما المستحدث للبنى اللاحقة سوى عامل تنظيم لما هو موزع , أو ترحيل وإضفاء خاصية جديدة لما هو مبتكر تطلبته ضرورة الحياة , ومرتبط بالجذور . لكننا لا نغفل دانب الانتحال الذي توسعت رقعته بهذا الشكل أو ذاك .
إن الـتأثير والتأثر سمة من سمات الوجود , وما تعدد نظريات النشء والتكوين إلا ّ لتحقيق مجموعة من الجهود , لوضع لبنة في مشيـّد الوجود الديني والفلسفي والاجتماعي والسياسي ..الخ . لذا نرى أن الشعوب تتأثر ببعضها , وتنقل المفاهيم والأفكار والطقوس , سواء كان هذا في ما يخص الواقعة , أو الشخصية أو طبيعة البنية الفكرية التي تضم شتى أشكال الحراك الثقافي . فحين أتخذ (الفريجيون ) طريقهم إلى أوربا وشيدوا لهم عاصمة (أنقــورة ) . وظلوا زمنا ً ينازعــون آشــور ومصر السيادة عـلى الشرق الأدنى , واتخذوا لهم إلهة أ ُمـّا ً تدعى( ما ) ثم عادوا فسمّوها ( سيبيل ) . واشتقوا هذا الاسم من الجبال ( سبيلا ) وعبدوها. وقد سحرت هذه الخرافات لب اليونان وتغلغلت في أساطيرهم وأدبهم . كما وأدخل الرومان الإلهة سيبيل رسميا ً في دينهم . ( 1 ) , هذا جميعه خضح لضرورات التشكل الحضاري والمعرفي , وإندرج في باب البحث عن الوسائل من أجل خلق حالة التوازن مع العالم . فهذا التأثر والتشكل الذي ألزم الابتكار والانزياح , خلقته طبيعة المنتج الجديد للشعيرة , وهذا أيضا ً ما حصل مثلا ً لنبات ( اللـّفاح ) , الذي هو نبات أسطوري كنعاني يسعد على الإخصاب . يقابله أو يماثله نبات ( اليبروح ) , وهو نبات أسطوري إخصابي أيضا ً , تتداو له شعوب في جنوب أفريقيا ــ حسب ما ذكر ( جيمس فريزر ) . إن ما نقف عليه هو وجود تماثلات في الوظيفة , وتشابه واختلاف في الشكل . وهذا يحيلنا إلى حقيقة التبادل الثقافي , سواء كان هذا مرتبط بما ينتجه العـقل الجمعي , أو الذهنية الشعبية , أو تكون التأثرات قد حصلت مباشرة . أيمن خلال طرق التبادل الثقافي المتعارف عليها . وفي كلا الحالتين تحصل فكرة التأثير والتأثر . إن اخلص إليه ( ديورانت ) ؛ أنه لاتوجد سلالة صافية , ولم توجد قط ثقافة لم تتأثر بثقافة جيرانها أو ثقافة أعدائها . ( 2 )
ولعل ما يهمنا في هذا الصدد التأثرات بحضارة وادي الرافدين , وبنياتها التي شيدت فكرا ً وفلسفة ونظما ً وملاحم , ولعل ملحمة جلجامش واحدة من النصوص التي تأثرت فيها الشعوب , وأنشأت نصوصها , مستفيدة من تشكلانها الداخلية وهو تأكيد على انتقال البنية وليس العناصر الخارجية ( 3 ) . لكن ذلك خضع في بعض الانتقالات , سيما في الخطاب التوراتي , حيث شكل ذلك اختراقا ً وتجاوزا ً للثوابت . وهذا ما يؤكد أن النص التوراتي على الرغم من كثرة أساطيره , يساعد على معرفة العوامل التي أسهمت في إنتاجه وتحققه . ومن هذه العوامل المهمة ؛ التأريخ والمجتمع والعلاقات الثابتة والمتغيرة والظروف الموضوعية الأ ُخرى , مضافا ً إليها الشرط الذاتي . وقد ساهمت هذه في بلورة الخطاب التوراتي , وصياغة البنية الذهنية العبرانية . إن سِفر التكوين التوراتي , أكثر الأسفار انفتاحا ً على حضارة وثقافة العراق وكنعان ومصر , ولهذا تعددت المؤثرات فيه ( 4 ) .لكنه أيضا ً تعرض للانتحال وتغيير الثوابت . كما حصل للكثير من الحكايات والأساطير والطقوس . ولعل تأثير العلوم في حضارة وادي الرافدين على عـلوم شعوب أخرى كان واضحا ً , مثلها مثل ما كان في مجال الأدب والمعتقدات , فقد انتقلت أيضا ً في بلاد اليونان مثلا ً الكثير من المفاهيم في حقل العلوم وخاصة الرياضيات والفلك ( 5 ). ولعل أهم التأثرات كان مع ملحمة جلجامش , لما لهذه الملحمة من امتدادات في آداب الشعـوب , وصولا ً إلى التوراة . فهي وكما أكد ( وليم إمبسون ) من أن بطلها حكم في أوروك في حوالي 2400 ق.م . أي قبل زمن الإلياذة بأكثر من ألف عام . ومع ذلك فإنها تفوقها في إثارة الإحساس بالمعاصرة . ويعتقد بعض الدارسين أن الملحمة ذات تأثير كبير على نشأة فن الملحمة عـند اليونان . كذلك انتشارها في أقطارا أخرى وعـند شعوب مختلفة , حيث عـُثر على أجزاء من الملحمة في جنوب تركيا . كما تشير بعض الأجزاء التي عثر عليها في فلسطين إلى وجود نسخة باللغة الكنعانية أو الفلسطينية المتأخرة . وهذا يؤكد معرفة كتـّاب العهد القديم بالملحمة ( 6 ) .
لذا نرى , ومن منطلق هذا الحقل المعرفي , إن ما تناولته الملحمة من قصص ومعتقدات شكلت المادة الفكرية , سواء كان هذا ما يخص المعتقد الديني , أو الفكر الأخلاقي الذي يشف عن مخبأ سياسي واجتماعي . منطلقا ً في بعض شذراته من أ ُسس فلسفية , مثل جدلية الحياة والموت , وثنائية الخير والشر , الفناء والانبعاث . لقد هيأت الملحمة جملة أفعال ذات دلالات واضحة في المعتقد والأخلاق والحكمة . كما هو واضح في سياقها , وطبيعة مجرى أحداثها , كالرحلات التي نفذها جلجامش بصحبة أنكيدو إلى غابة الأرز . أو رحلات جلجامش بمفرده لتحقيق حلم الخلود . وهذا بطبيعة الحال كشف عن متغيرات كثيرة لصالح شخصيته كملك . إن التماثل بين التوراة والملحمة شمل أكثر من ثوابت فيها . ولعل قصة الطوفان واحدة من تلك الثوابت . فقصة الطوفان اليونانية مثلا ً تتماثل مع قصة الطوفان البابلية التي رواها ( أوتونابشتم ) . مما يدل على تأثر الأولى بالثانية . فقط هناك استبدال في الشخصيات . فبدلا ً من أوتونابشتم بإرشاد الإله ( أيا ) , فإن ( ديوكاليون ) بطل الطوفان في القصة اليونانية بإرشاد الحكيم ( بروميثيوس ) (7 ) . وكما أكد الدكتور ( طه باقر ) على الاكتشافات التي تمت في أوغاريت المدينة الكنعانية القديمة , حيث أ كتشف أدبا ً كنعانيا ً يعود زمنه إلى منتصف الألف الثاني ق. م , أي ما بعد الزمن الذي دون فيه أدب العراق القديم بما لا يقل عن خمسة قرون . ومثل هذا يقال عن الأدب العبراني القديم الذي تضمنته التوراة . ( 8 ) , وقد أكد أيضا ً على شمول هذا الرأي والاكتشاف ( الأوديسة والإلياذة ) اليونانيتين . إن قصة الطوفان في الملحمة لها أ ُصولها القديمة متمثلة فـــــي قصة الطوفان السومرية وبطلها ( زيوسدرا ) . وهناك تشابه بينها وبين روايــــة الطوفان فــي ملحمة
( أتراحاسس) وبين رواية التوراة ويعتقد ألدكتور ( طه باقر ) أن كلا الروايتين ترجعان إلى نفس الحادثة , وأن هذه الحادثة وقعت في العــراق القديم . ومما يؤكد مثل هذا التماثل وجود اليهود في بابل , حيث كان الكهنة يمارسون طقوسهم وشعائرهم وتحرير أهم فصول التوراة . ثم أن الأسفار الأولى قد أخذت شكلها أثناء الأسر البابلي متأثرة بما أطلعوا عليه من الوثائق المسمارية المدونة بالسومرية والبابلية والخاصة بخلق الكون والإنسان والحياة والموت والثواب والعقاب . مما يدلل تأثر مدوني التوراة بالموروث السومري . (9 ) غير أن هذا لم يكن من باب المثاقفة , بقدر ما كان جل نواياه إسباغ الشرعـية والقداسة على ما هو منتحل ومدون ومرحّـل . وقد أضفى التماثل والتشابه , حتى شمل شخصيات وثوابت أخرى . فكما ذكرنا أن الآثار التي تركتها الملحمة في ملاحم الإغريق مثلا ً , سيما البني الفنية , كذلك شملت ً تكرار صفات الشخصيات , وحصرا ً في نمط البطولة كما هي في شخص ( هرقل ) الإغريقية , وهو مثال واضح وقوي على هذا التأثير , حيث أطلق العالم الإيطالي ( سباتي نو ماسكاتي ) على جلجامش لقب ( هرقل السومري ) , ذلك لأن المصير المأسوي الذي تعرض له جلجامش , ورحلاته كانت تؤكد صياغة هرقل على وفق مقاسات شخصية جلجامش . ( 10 ) وكما أكد الدكتور ( طه باقر ) كون البطل جلجامش أنتقل أسمه إلى معظم الآداب القديمة , وأن أعماله نسبت إلى أبطال أمم أخرى مثل هرقل وآيل والإسكندر ذي القرنين والبطل أديسيوس في ألأوديسة . ( 11 ) فبين الشخصيتين شبه كثير , حيث أكد الباحثون عــلى أن أ ُصول شخصية هرقل مستقاة من ملحمة جلجامش , وقد وصلت إلى اليونان عن طريق الفينيقيين , فكلا البطلين من أصل إلهي , كلاهما إتخذ صاحبا ً وصديقا ً مثل أنكيدو ويوليوس , وتأثيرات الأنثى على الشخصيتين تجلت في ( عشتار ودينيرا أو الإله هيرا ), كلاهما قتل الأسود وتغلب على الثيران السماوية المقدسة . وإلى غير ذلك من التشابهات والتماثلات .
أما في مجال الحبكة القصصية وتكرارها فقد تجسد ذلك في قصة الإله ( أتانا ) والنسر وما احتوته من مفارقات ومعاني . فالإله أتانا كان قد وصل إلى السماء وحصل على نبات النسل , بدليل ما ورد في قائمة الملوك السومرية أن إبنه ( باليخ ) قد خلـّفه في الحكم . ,هناك أيضا ً قصة مشابهة في بلاد اليونان حول النسر والجعـل . وهناك أ ُسطورة يونانية أ ُخرى بطلها ( بليروفون ) تتحدث عن صعود الإنسان إلى السماء على ظهر حصان يدعى ( بيكاسوس ) ( 12 ) . والذي حصل هنا هو الاستبدال والتغيير , ثم الإضافة . وهذا النمط من الـاثر والتكرار , يتصل مباشرة بالمعتقد , فالإنسان دائما يبحث عن ما يناسبه , ويضع أمامه المبرر الذي يحيل إلى التفسير في ما هو حاصل . فالعقم واحدة من الظواهر التي عالجتها الأسطورة , وكررتها على شتى الصور , وعند مختلف الشعوب . أما في مجال حالة الانتحال , فهي أيضا ً واردة وكثيرة , خاصة حين يكون المرمى السياسي , هو الحاضنة التي تحتوي مثل هذا الحراك الثقافي . إذ يشير الباحث ( يوسف يوسف ) وهو بصدد كشف مثل هذه التأثرات والتي تخص البنية الذهنية , و بشكل يشير إلى الميل نحو التعصب الذي يعمد إلى الإلغاء والإدعاء بالريادية , في محاولة لمحو الجذور بإدعاء السبق , حيث يصرّح الحاخام الصهيوني إسحاق كوك من أن : (( جميع حضارات العالم ستجدد بولادة شعـبنا من جديد , وستحل جميع النزاعات )) ( 13 ) , وبمثل هذا الإصرار نرى ما احتوته صلاة نهاية الأسبوع اليهودية القائلـــة (( ربّ لا تجعــل للمرتدين رجاء , ولتمحــق جميع المسيحيين في الحال )) . وما يخلص إليه الباحث ( يوسف يوسف ) ؛ كون الصهيونية العالمية تلجأ على الدوام إلى تغليف دعايتها ضمن مادة أدبية تبدو محايدة وغير سياسية في نظر القارئ العادي . ويتشعب هذا الإخطبوط مابين وسائل الإعلام لإنتاج الثقافة التي تريد أشاعتها . ( 14 ) لذا نجد إن التماثل في اكتساب الخصائص والصفات والسيرة , وبالتالي النشأة ؛ يتكرر في ما بين الأسطوري القـَبلي والنص الديني . وهي تماثلات تأخذ من العــقيدة أو الطقس والسيرة , بما يساعدها على تأسيس البناء العام لثيمة النص الجديد . ومن الملاحظ , أن عــنصر الإعجاز ونفاذ تأثير المعجزة , أهم ما يعتمده المؤسِس أو المتبع والخالق لهذا التناص . , لأن المعجزة تحمل عناصرها المؤثرة المباشرة وغير المباشرة , ومن ثم المثيرة للعاطفة . وبالتالي فإن فيها ما يؤهلها كثيمة تحمل صفات ــ المقدس ــ . فلو نظرنا بدقة إلى الشعيرات والطقوس التي احتوتها الأساطير , وسريانها إلى الأزمنة المتقدمة , لتمكّـنا من الوقوف عند كثير من هذه الخصائص المشتركة , والتي اكتسبت قدسيتها من التكرار . ومما تحمله من دلالة البنية الذاتية فيها . ولعـل أسطورة الملك ( سرجون الأكدي ) , خير مثال يمكن التثبت من خلاله على نمط النشأة المعجزة , وتماثلها مع قصــة ( موسى ) ( 15 ) . إذ أن التماثل يكون مكتسبا ً كــل الخصائص , مما يحيــل القــول إلى أن الثانــية تمثلت
بالأ وُلى . فإذا كان ــ الصندوق ــ مــن حمــل موسى فــي مجرى نهــر النيل , فإن ــ السفط ــ هـــو الناقــل لجسد ( سرجون) طفلا ً رضيعا ً . وهذا أيضا ً ما يتماثل بين جلجامش وشخصية موسى في الصفات والعناصر . من هذا نستطيع القول ؛ إن النص التوراتي أعتمد على خاصية الأسطورة وتأثيرها ووظائفها . واستفاد منها لصياغة شخصياته . وخاصة المركزية منها . وهي شخصية موسى المثيرة للنقاش والبحث . فهي شخصية غريبة الأطوار ومتنوعة العناصر ــ كما ذكر المعموري ــ . فشخصية موسى التوراتية من الصعب التثبت من طبيعتها التاريخية , لأنها من مولدات أ سطوره مرتحلة من العراق القديم , , خاصة علاقته بمصر وفرعون , وقصة خروجه باليهود من مصر نحو سيناء , وما تشكل من حكايات داخل مصر وخارجه .
إن مجمل الإضافات التي أ ُسبغت على شخصية موسى , وضعته في مصاف القادة المنقذين لليهود, ذلك لأن الذهنية العبرانية أرادت إنتاج أ سطوره لبطلها القومي . ولم تجد أفضل من إ سطوره الملك جلجامش وسرجون , فأسقطتها عليه . خاصة وأن أ سطوره جلجامش كانت قد وصلت إلى مصر , وتم اكتشاف قطع من الملحمة في تل العمارنة , حيث قصر الإخناتونية . إذ أن موسى هو أحد قادتها أو كهنتها (16 ) . فهذا التماثل بين الشخصيتين موسى وجلجامش وثالثهم سرجون , يشير إلى نيـّة العبران لصياغة بطلهم . سيما وأن مجموعة الخارجين على القوانين والأنظمة هم من تبنى فكرة كهذه أمام النظم الفكرية للكنعانيين . وفي هذا أشار( فرويد ) فـــــي كتابه ( موسى والتوحيد ) (17) , حيث قام بدراسة ذلك وبيـّن أهم الخصائص والمتشكلات . كذلك الأسباب التي دفعت لصياغة الشخصية المنقذة في التأريخ اليهودي , وإعطائه صفة البطل القومي . إن صياغة شخصية موسى صياغة مزدوجة , كما هي شخصية جلجامش وسرجون , تشير إلى أن هذه الشخصيات ليست سياسية خالصة , وليست دينية خالصة , بل تجمع بين الوظيفتين . فمن المعروف أن جلجامش كان يتكون من ثلثين إله وثلث بشر . كذلك سرجون , فإنه يحمل خصائص الوظيفتين . لذا فموسى أيضا ً كانت له وظيفة سياسية في قيامه بقيادة اليهود من مصر عبر سيناء . ثم أنه داعـية دينية أيضا ً . لذا فهم يؤدون وظائف دينية اقترنت أصلا ً مع الوظيفة السياسية , لأننا لا نستطيع الفصل بين ما هو ديني , وما هو سياسي في حضارات الشرق الأدنى , لوجود ترابط وثيق , وصلة دقيقة بين الخطابين الديني والسياسي . حيث أن الآلهة يختارون الملك ممثلا ً للسلطة الإلهية ــ السياسية على الأرض , مثلما كان جلجامش الملك ممثلا ً للآلهة , ووسيطا ً بين الإله والشعب . وهذا واضح في الملحمة المسماة باسمه , حيث جعله الإله ( إنليــــل ) عالي الرأس . فكان الملك في الشرق القديم أنموذجا ً يمثل النظام الأبوي المقدس , لأنه حاز على صفة الأ لوهة المقدسة . ويوجد فرق جوهري بين شخصية موسى ومعظم الشخصيات البطولية , إذ اكتفى موسى بصفته النبوية , مطورا ً لها , حاملا ً منظومة التوحيد التي عـرفها في مصر , وأخذها معه وهو يقود العبران نحو صحراء سيناء .
لقد حاز موسى صفة المنقذ بعد أن مرّ بعقبات كثيرة , حتى حقق فعل الإنقاذ , اعتبارا ً من ولادته المعجزة , مرورا ً بسيرته داخل مصر وقتل أحد المصريين ثأرا ً لأحد العبران . لذا كان له دور القائد والسلطة والراعي للشعب . إن تمثل البطل المنقذ يبدو في خاصية الإخصاب , لأنه يمثل السماء المخصبة للأرض . والخصب هنا هو تبلور رمزي وشعائري سحري , يرتبط ارتباطا ً مباشرا ً بالمنظومة السياسية التي يتوقف على قدرتها وطاقتها نوعية ومستوى الخصوبة في الحياة . وفي الخصوبة عناصر تؤشر لمجموعة من العلاقات المشتركة بين ما هو سياسي ــ اجتماعي ــ اقتصادي . هذه كلها تتمركز معا ً في شخصية الملك ــ الكاهن ــ الإله النبي موسى ( ناجح المعموري /موسى ) . ثم أن فعـل الولادة الذي قدمته لنا الأساطير الخاصة بالبطل الملك قاد حتما ً إلى عتبة ثانية ومهمة . ألا وهي الإخفاء ألقصدي الذي لا يؤدي إلى الموت , وإنما يقود إلى الحياة والإنبعاث , مثلما وجدنا في الأساطير العديدة . ولكن عبر منظومة متتالية من ألإشكالات الصعبة والمعقدة التي في حال تحققها أو تبلورها تضع أمامنا الفعل المتحقق , بإعتباره تجسدا ً مخلـّصا ً ومهما ً , يضفي على المولود من خلال كونه منقذا ً لشعب ما , يقود للخلاص من اضطهاد الملك . وهذا ما وجدناه قائما ً بين موسى وفرعــون .
إن أ سطوره البطل المنقذ مرتحلة , قد استلهمتها كثير من الشعوب , وأعادت صياغتها وفق شروطها الوطنية وخصائصها الجغرافية , (18) لأن البطولة ليست خاصة بشعب من الشعوب , وإنما هي كلية وموجودة عند كل الشعوب . لهذا فإن الشعب أو القبيلة يستلهم أ سطوره البطل ويعمل بها بعد حذف مالا يناسبها , وإدخال ملامح وطنية جديدة . لكن العناصر الجديدة لا تستطيع إخفاء الملامح الأولى المكونة للنص الأول . لأن المجتمعات المتميزة بالشفهية تتصف بقدرة هائلة على الاحتفاظ بماضيها , وكأنه حاضر باستمرار . بحيث يبرز الزمن ذا البعد الواحد . والجدير بالذكر هنا , هو أن الذاكرة فيها ليست آلية , إنها تحوّر وتبلور وتبدل وتـُغيـّر فيما تنقله وتدركه من موقع الثقافة التي تؤثر فيها . فالإنتاج هنا محاولة لإعادة الهيبة القومية والاستفادة من مظان التأريخ , وما لحق باليهود من حيف بسبب الأخطاء التأريخية المترتبة على مجمل البنية المكونة لوجودهم . خاصة بعد السبي البابلي , وعلاقة دانيال بحاضرة بابل , وبالتالي نبوخذنصر وتقربه من بلاط الملك , حيث تأسست حكايته تلك مع قصة يوسف مع الفرعـون ووجوده في مصر في تلك الحقبة , ووسط الاضطراب والقلق على الوجود كان لابد لليهود أن يتبصروا في مستقبلهم وصيرورتهم , والمتمركزة في التمحور وإيجاد البديل القومي , سيما وأنهم لا يمتلكون ــ وأقصد العبران ــ ذاكرة مؤسسة , يمكن الاستناد عليها تاريخيا ً . وذلك يرجع إلى كون الذاكرة تتأسس عبر تأسيس المكان . فتاريخيتها من تاريخيته , واليهود عاشوا على الشتات , لا مركز لهم . لذا توجب عليهم إدّعاء مثل هذا التأريخ والمكان صناعة , من خلال التعلق والتشبث بالنص . ونعني به التوراة , بعد انتقال ( دانيال وارميا وحسقيال ) من بابل نحو فلسطين , حيث دونوا التوراة بأسفاره التي رشحت تأريخا ً سياسيا ً , عـبر الارتباط بالمكان المفترض , وإبرازهم على أنهم قومية مضطهدة , عانت الشتات والتوزيع , وأن عودتهم إلى الوطن الأم , عودة مشروعة لإعادة الوطن الأم والتأريخ القومي .
في هذا المجال جرى التشبث بالمكان وبالشخصية , ومحاولة اقتفاء أثر حكايته عبر حكايات أ خرى . وهذا مما يثبت المقدس المنبثق من المعجزة في الولادة والنشأة . أي أنه البطل القومي الذي تطلبته الضرورة القومية والتاريخية , من أجل إعادة الاعتبار لتأريخهم القومي عبر بطلهم القومي المنقذ والمخلـّص من هذا التشبث في صياغة البطل , إضافة إلى إرثهم أو مأثوراتهم ــ كما أكد الأستاذ محمد العزب ــ كون اليهود يمتلكون مأثورات كثيرة خارج التوراة . وهي عبارة عن صياغات أ أسطورية وخرافات ( 19 ) , نـُسجت عبر القرون حول الشخصية العملاقة لزعيمهم الأول ومؤسس ديانتهم . وقد سعت هذه المعتقدات إلى تقديس شخصية موسى , وإضفاء خاصية الغموض عليها . بل تشكلها عبر رؤيتهم وإستراتيجيتهم السياسية والقومية . من هذا تطورت النظرة إلى شخصيته , وذلك بإضافة الكثير من الحكايات والأساطير عليه . ومنها أ سطوره كونه قائدا ً عسكريا ً , وكان ضابطا ً مصريا ً في أثيوبيا , وما هنالك من حكايات أسبغها اليهود على شخصية منقذهم وقائدهم من بعد الشتات . وفي هذا الصدد لم يكتف اليهود بمحاولة إضفاء ترحيل خصائص من الأساطير خاصة أ سطوره سرجون وجلجامش , بل حاولت أن ترحـّل مجموعة المنظومات التوراتية من قبل العبران , وذلك نقلا ً عن المصريين , أو عن الأقوام الجزرية الموجودة في سيناء . من هذا نرى أن العبران قد استعانوا بملحمة جلجامش من أجل صياغة نص عن الشخصية العبرية . ومن تلك الصياغات ما حصل بعد قرار الفرعون بقتل كل طفل تلده امرأة عبرانية . وهذا القتل يمثل ميثيولوجيا تطورت لا حقا ً في الحفريات الجماعية . كما أن النص التوراتي قدم كشفا ً عن قوة وشجاعة القابلتين اللتين تحديا فرعون وأكدتا بأن النساء العبرانيات يلدن بدون مساعدة قابلة . ولعل أهم الصياغات الأسطورية المضافة على شخصية موسى ؛ هي ميزاته الرسمية الرفيعة , والتي ضحى فيها من أجل شعبه , وخسر إلى الأبد كل تلك الامتيازات , حصد من بعدها مقابلة متاعـب الشتات السينائي والجوع .
لقد أظهرت التوراة شخصية موسى على شكل يساهم في صياغة شخصيته كقائد للشتات , فهو لم تشده كثيرا ً الحياة في قصور الفرعون , وتغريه الحضارة المصرية التي نعم فيها لفترة طويلة . ومقابل هذه الحياة المرفهة كان قارئا ً جيدا ً لكل حكمة مصر المدونة على البردي , وتشبع بكل ما هو مفيد له في صقل شخصيته . وهي صفات استفاد منها اليهود بذكاء لصياغة وظائف له . المراد منها ترجيح شخصيته كبطل مختلف عما سبقه من الأبطال . وبهذا دفعت التوراة وأساطيرها مفهوما ً مفاده ؛ أن موسى ضحـّى من أجل شعبه ورسالته , مؤكدة على دوره الثقافي والمعرفي العام , الذي صاغ ديانتهم السماوية . ونصوص التوراة مرت عبر شفاهيات التداول والتدوين المتعاقب حتى آخـر تدوين في العصر البابلي , الذي قام فيه عزرا مازجا ً بين التصورات لما هو مستقبلي , مستعينا ً بما هو حاضر في بابل . وهذا التدوين يتضح فيه القصد والمرمى السياسي والقومي والفكري , لخدمة الأهداف العنصرية والعرقية , ومن ثم الاستيطان في إيجاد وطن أم لليهود . متطرقة إلى حق العبران في العيش والاستيطان , لأنهم شعب الله المختار . مبلورين نظرتهم في وطن يمتد من النيل إلى الفرات . مقدمين من أجل ذلك القرابين والأ ُضحيات البشرية عبر التأريخ . من هذا نرى أن شخصية موسى التوراتية ؛ شخصية مركبة من أساطير سومرية عراقية عامة , أستطاع العبران إضفائها على شخصيته , وبلورتها في شخصه باعتباره قائدا ً ومنقذا ً . ذلك لأن الحفريات في فينوس وأوغاريت دلت على أن قصص العهد القديم عن الخليقة وبرج بابل والطوفان أ خذت من الأساطير السومرية وسفر الملوك في العراق كسرجون الأكدي والبطل السومري جلجامش . إن كتبة التوراة ــ وكما ذكرت ( ساندرز ) , كانوا على علم بقصة ملحمة جلجامش ,وأخبار الملك الخامس لحاضرة أ ُُوروك ( 20 ) . لذا كانت الصياغة الجديدة , سواء كانت لشخصية جلجامش ماثلة في شخصية موسى , أو تماثل بقية الشخصيات والقصص الأسطورية والشعيرات التي أسهمت في بلورة المواقف . فشخصية ( سيدوري ) صاحبة الحانة , في الملحمة , هي شخصية ملـّغزة , عارفة موجهة لمسار الملك , فهي إضافة لوظيفتها في تقديم الخمور لكن لغتها تشبه إلى حد ما لغة ( كيركا ) وهي كانت نفسها إبنة للشمس وتقع جزيرتها التي تعيش عليها في البحـــر . حيث يختلط الشرق بالغرب . وقــــد تماثلتا فـــي بث الفلسفة مؤداها كل وأشرب وأمرح ( 21) .
ومن التناصـّات في هــــذا الضرب من التشابه بين طوفان التوراة وطـــوفان الملحمة . ففيها لا يكتفي باستدعاء الإله ( أنليل ) فحسب بل يستدعى الأنوناكي . وهم آلهة العالم السفلي الذين أثارت صواعقهم ثوران المياه . وقد كان وصف العاصفة أكثر إتقانا ً وتأثيرا ً من رواية سفر التكوين في التوراة . وقد استخدمت الأحداث نفسها في رواية التوراة . (22 ) فعلى الرغم من رغبة العبرانيين في نسيان آشور وبابل وكل ما يتعلق فهما , لكن بعد سقوط نينوى شهد ظهور الأشكال الشعرية الحديثة من الأناشيد الغنائية الجماعية . مثلها مثل تأثر الإغريق بما كان متداولا ً من الشعر . ولعل من الممكن لشاعر الأوديسة من الوجهة التاريخية أن سمع قصة جلجامش بطريقة مباشرة . إذ لم تكن الآلهة البابلية وعالمها إلا ّ لتظهر من جديد في ديانات البحر المتوسط المتأخرة .كذلك بقي الأبطال وإن تبدلت أشكالهم يرتحلون ناحية المغــرب كارتحالهم ناحية المشرق , فجلجامش يتمثل فــي شخصية الإسكنـدرفي العصور ا لوسطى ( 23 )
في مجال المكان والعليـّات كان التماثل واضحا ً بين التوراة والأساطير القديمة . وذلك لما يشكل المكان المرتفع والعالي من قيمة مقدسة , حيث أخذ قدسيته من دلالة العليّات باعتبارها أماكن قريبة إلى السماء ومركز الرب . لذا فالعلاقة فكرية دينية , تدعـو إلى حالة وفعل الربط بين السماء والأرض .من هذا لاحظنا القيمة المشكـّلة لهذه الأمكنة . وهي عموما ً علاقة إخصابي ابتداء من نزول المطر , باتجاه إقامة المذابح التي تقدم عليها الأضحيتات إلى الرب . ويشكل الجبل الركيزة الطبيعية كمكان للعبادة . وقد أستعيض عنه في المناطق السهلية بالزقورات في حضارة وادي الرافدين . وقد تعامل نص ملحمة جلجامش مع الجبل باعتباره مكانا ً مقدساً وقد أكد العالم ( جان بوتيرو ) على أن { التوراة هي إعادة لملحمة جلجامش , حيث وزعت النصوص بين الأسفار التوراتية , وذلك بنقل وترحيل وظائف كاملة عرفتها الحضارة العراقية القديمة منذ السومريين . وهذا ما أكدته الدراسات العـديدة التي تناولت بالدراسة التوراة , خاصة حين تم اكتشاف لوح الطوفان في فينوس . حيث تعتبر الحضارة السومرية هي أول الحضارات التي ساهمت برسم حدود المكان في الطقوس والعقائد والشعائر . }( 24 )
ونلاحظ أن ما يقابل الطقوس التي كانت تقام على الجبل أو العلـيّّات في ما ذكرته التوراة , هي طقوس مماثلة لما كان في تأريخ مجتمعات العراق القديم , والدليل على ذلك ما حفلت فيه ملحمة جلجامش من أشارات إلى المكان المرتفع باعتباره مكاناً مقدسا ً ففي سفر جلجامش وأنكيدو إلى غابة الأرز , كان الجبل واحد من الأمكنة المشار إليها باعتبارها رموز ودالات على بنى فكرية كما هو واضح في هذا المقطع من الملحمة :
{ وأمام الإله شمش حفرا بئرا ً
وصعد جلجامش إلى الجبل
وقدم وجبته إلى ( البئر )
و(قال) أيها الجبل أرسل ( لي ) حلما ً ً } (25)
وقد ورد ذلك مرارا ً لتأكيد القيمة الفكرية , لأنهما تعرضا لحارس الغابة ( خمبابا ) وصرعاه أرضا ً :
{ سوف نمسك خومبابا المقدس وندمر شكله
ونرمي جثته بعد قهره في البرية
وعند بزوغ الفجر , سوف نسمع الكلام
المحبب من شمش } (26)
من هذا يرى ( مرسيا الياد ) أننا بإزاء سلسلة من المفاهيم الدينية والصور , مترابطة فيما بينها , يفصلها نظام يمكننا أن نطلق عليه ــ نظام العالم لدى المجتمعات التقليدية ــ . وبذلك يشكل الجبل مكانا ً مقدسا ً , ويرمز إلى الانقطاع . عبره تكون هنالك نافذة يمكن من خلالها العبور من إقليم إلى آخر , من السماء إلى الأرض , أو من الأرض إلى العالم الأسفل كما ويعبر عن الاتصال بالسماء (27 ) . ولهذا كان ماذ ُكر في سفر الخروج 3ــ5{ لا تقترب إلى هنا , أخلع نعليك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة } , إشارة إلى المكان الذي ورد في النص وهو الجبل والمخاطب هو موسى (28) ) لذا فالاختيار كان للمكان من قبل الرب , حيث قام موسى بممارسة المعتقد . فالمكان لا يكتسب قدسيته إلا ّ عبر ما تقام عليه من طقوس وشعيرات . وهذا ما فعله موسى عبر أداء طقوس جماعية , تتخللها الشعائر . كذلك ما كانت تقام من شعائر المذابح وتقديم الأضحيات , سواء كانت من غلـّة الأرض أو من الحيوانات . لقد كان للمكان دور مهم في الحضارات الشرقية , وكررتها أسفار التوراة أيضا ً . لذا نرى أن البنية الذهنية العبرانية قامت بترحيل عناصر الديانة المصرية والعرا قية والكنعا نية ,و لم تكتف بذلك , بل طورت عليه بأن إعتبرت الجبل ليس مكانا ً مقدسا ً فقط, بل منقذا ً ومحددا ً للعـنف والموت , ومسيطرا ً على عناصر الحياة . ويـُشكل مثابة للجوء كما هو في قصة الطوفان . (( 29 ) )
إن الاستعاضة بالأبراج والزقورات , قد أضفى ميزة جديدة لهذه القدسية , . كما هي زقورة أ ُور وبرج بابل . وقد قيلت آراء متعددة حول الفكرة التي تمثلها الزقورة , ومنها [ان الزقورة بمعبدها العلوي تمثل محلا ً لاستراحة الإله , وهو في طريقه من معبده الأرضي إلى السماء . ومن الملاحظ أن هذه الفكرة عن الزقورة لها ما يشابهها في التوراة . وبنفس الدرجة من العظمة والقدسية حفلت فيها الأبراج باعتبارها علـيّات أيضا ً . وقد أثارت هذه الأماكن مشاعـر المشاهدين , إذ نرى ( هيرودوتس ) 480 ــ 425 ق. م يصف البرج بانبهار روحي خالص .
من كل ما تقدم يمكننا القول أن التأثرات الحاصلة في مسيرة التأريخ البشري , حصلت لضرورات البقاء من خلال الاستحداث وإتباع الأثر , وهي ممارسات في المجال الثقافي الحيوي , الذي يجوز مبدأ التأثر والتكرار , من باب البعد الإنساني الخالص . وطبيعي يشوب هذه الممارسات شيء من التجاوزات التي تورث أخطاء تاريخية من شأنها خلق صراعات جائزة وغير جائزة , لأن المقياس في هذا النتائج التي تترتب على مثل هذه الممارسة كاشفة عن نواياها . فما ذكرناه وما لم نذكره من هذه التماثلات في التأريخ , وجدت لها مستويات مختلفة , كان قد درسها المتخصصون . عموما ً ثمة مسوغ يحيط بالتبادل الثقافي والمعرفي , وهو مسوغ يعني أيضا ً حركة التأريخ ونتجه المتمثل في الجهد البشري الذي يثري الحياة على الدوام .
———————————————————————————————
الهــوامـش /
1ــ ول ديورانت / قصة الحضارة ج1 / ترجمة د. زكي نجيب محمود / الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية . ص305
2 ــ نفسه ص 3.9
3 ــ ناجح المعموري / الأسطورة والتوراة / المؤسسة العربية للدراسات / 2002ص57
4 ــ نفس المصدر ص59
5 ــ د. فاضل عبد الواحد علي / من ألواح سومر إلى التوراة / دارا لشؤون الثقافية ــ بغداد 1989 ص230
6 ــ د. محمد خليفة حسن أحمد / الأسطورة والتأريخ في التراث الشرقي القديم / دار الشؤون الثقافية ــ بغداد 1988 ص 11
7 ــ د . سامي سعيد الأحمد / جلجامش / دار الشؤون الثقافية ــ بغداد 1990 ص 101
8 ــ طه باقر / ملحمة جلجامش / دار الشؤون الثقافية ــ بغداد 2003 ط6 ص 13
9 ــ د . فاضل عبد الواحد / سابق ص 344
10 ــ د ز محمد خليفة حسن / سابق ص10
11 ــ د. طه باقر / سابق ص48
12 ــ د. فاضل عبد الواحد / سابق ص 214
13 ــ يوسف يوسف / الأغيار في الثقافة اليهودية / دار القلم ــ دمشق 2000 ص 22
14 ــ كذلك ص 39
15 ــ ناجد المعموري / موسى وأساطير الشرق / الأهلية للنشر والتوزيع ــ عمان 2001 ص 33
16 ــ نفسه ص 7
17 ــ سيجمند فرويد / موسى والتوحيد / ترجمة جورج طرابيشي / دار الطليعة ــ بيروت 1976 ص57
18ــ ناجح المعموري / موسى / سابق ص 67
19 ــ نفسه .
20 ــ ف . ك ساندرس / ملحمة جلجامش / ترجمة محمد نبيل وفاروق حافظ القاضي / دار المعارف بمصر ص 13
21 ــ نفس المصدر ص 35
22 ــ كذلك ص 37
23 ــ نفسه ص 41
24 ــ ناجح المعموري / موسى / سابق
25ــ د. سامي سعيد الأحمد / ملحمة جلجامش /الشؤون الثقافية ــ بغداد / 1990ص34
26 ــ نفسه 151
7 2ـ ناجح المعموري / مصدر سابق ص77
8 2ــ كذلك . ص74
9 2ــ كذلك . ص97
كما اعتمدت الدراسة أيضا ً المصادر التالية :
1 ــ الطيب تيزيني / أساطير بلاد مابين النهرين / ت . د . نجوى نصر / دا ر بيسان ــ بيروت .
2 ــ سيد القمني / ألأسطورة والتراث / دار سيناء للنشر 1992
3 ــ صموئيل نوح كريمر / الأساطير السومرية / ت . يوسف داود عبد القادر / طبعة المعارف ــ بغدا د1971
4 ــ فاضل عبد الواحد / من ألواح سومر إلى التوراة / الشؤون الثقافية ــ بغداد 1989
5 ــ جودت السعد / أوهام التأريخ اليهودي / الدار الأهلية للنشر 1998
6 ــ وليم إمبسون / قراءة في ملحمة جلجامش / ترجمة فلاح رحيم / مجلة الثقافة الأجنبية / العــدد 1 السنة التاسعة 1989/ ص 158
تداعيات الذهنية الشعبية في منظومة ملحمة جلجامش
جاسم عاصي
تـُعد ملحمة جلجامش , نصا ً شعبيا ً , من اعتبار تداوله في المناسبات والأعياد التي كانت تقام من خلالها الطقوس والشعيرات , حيث تسود أحداث ونصوص فصولها دكه المسرح والشوارع والساحات . وبهذا اكتسبت شعبيتها باقترابها من هموم الرعايا في اوروك أو سواها من الحواضر التي انتقل إليها النص ,فهي بحق نصا ً شعبيا ً , لأنه وازن بين تناول حياة الملك والحاضرة و إشكالات رعايا أوروك وأصبح جزءا ً من خزانة الكتب والوثائق آنذاك , أنها تتناول صراعات الإنسان مع نفسه , ومع القوى القاهرة , وتحكي عن قصصهم ولوعتهم , وما يعاملونه جراء الحيف الواقع عليهم . وفي النص , ما كان يعانيه رعايا اوروك من الظلم الاجتماعي , والسياسي , مصدره الملك ( جلجامش ) . وما استجابة الآلهة في خلق نظيره ( أنكيدو ) إلا ّ تلبية لحاجة الرعايا ورغبتهم في الخلاص . فقد تمثلت مشاهدها عبر أدائها وتمثيلها , وإلقاء مقاطع من شعرها , مصحوبا ً بحركات وإيماءات , كانت أولى جذور المسرح في العراق القديم . ولعل هذا السبب من بين ألأسباب العامة والذاتية الكثيرة التي وفرت للملحمة صفتها ومكانتها الشعبية بإقترابها من الرعايا . إن معالجة حيثيات الناس , سيما رعايا أوروك الذين استغاثوا إلى الآلهة لوضع حد لسياسة الملك ( جلجامش ) خاصة ما كان يثير حفيظتهم بصدد الذهاب بأطفالهم إلى معسكرات التدريب , كذلك ما كان يقوم فيه الملك في مناسبات الزواج , حيث يدخل مخدع العروس قبل زوجها . هذه الهموم وغيرها شكلت مادة الملحمة , التي بنيت على أساسها متغيرات كثيرة . كما وأنها بالإضافة إلى ما كان يؤدى منها في المناسبات , فقد كشفت عن محتوى المعبد من محظيات وغلمان يساهمون في طقس الزواج المقدس داخل المعبد ويؤدون وظائفهم داخله , وهو من الطقوس الشعبية . يضاف إلى هذا كون محتوى الطقسية التي حولت ( أنكيدو ) من مخلوق بري , إلى مؤنسن , ساهمت فيها طقوس منها المواقعة مع شمخت والحرث في جسدها بطقسية جنسية ذات صفة شعبية , على اعتبار أن الاتصال الجنسي هو من طقوس الأعراس الشعبية التي. ثم تناول تقدمات ( شمخت ) من الخبز وجعة الخمر ,التي مادتها الغلة الزراعية . وهي تدخل ضمن الصناعات الشعبية , لذلك اكتسبت شعبيتها من تداول صناعتها , وتوظيفها في تحويل البرّي إلى إنسان يمارس كل طقوس الحياة في أوروك , وعلى مختلف الأصعدة . ولعل علاقة (ننسون ) بـ ( انكيدو ) كان عبر طقس التبني ــ الأمومة ــ وهي توصيه بولدها في رحلته إلى غابة الأرز . وهي في مجملها طقوس احتفالية ساهمت في تصعيد عنصر المشاركة من قبل أنكيدو في فعل التغيير على صعيديه المادي والفكري , ونعني فيها , تغيير بنية الملك الأخلاقية , والفكرية عبر تغير ممارساته , إلى حد الاقتراب من الرعية , أو شعب أوروك . ويمكن اعتبار تبني أنكيدو لحماية ممتلكات الرعاة والسهر على مواشيهم لهو دليل على ممارسة طقس اجتماعي ــ شعبي , يدخل في باب مشغولات الناس وتأسيس علاقاتهم , عبر العمل الجماعي والتضحية . وما قام فيه أنكيدو , هو من ضمن الفعل الاجتماعي الشعبي , الدال على شهامة الرجل . كذلك يدخل في هذا الباب طقس ما قامت فيه ( سيدوري ) صاحبة الحانة , حيث بدت أمام جلجامش امرأة ذات سلطة معرفية , فقدمت له النصائح المتعلقة بالخلود والبحث . أي أنها شاركت على وفق منظورها المعرفي الشعبي الذي اكتسبته من وجودها في موقع مفترق الطرق , حيث تستقبل الراحلين والمسافرين , مما أكسبها رؤية واسعة للحياة , فكان إسدائها للنصح لجلجامش , دليل خبرتها الاجتماعية الشعبية أي تقديم المعرفة المكتسبة في حضرة الملك , وهي من باب النصائح التي تعتمد على تجارب شعبية ذات بنية جماهيرية , مستنبطة من التجارب اليومية , حتى أصبحت في حقل الحكمة الشعبية , فهي القائلة :
{ إلى أين ذاهب يا جلجامش
إن الحياة التي تبغيها سوف لا تجدها
عندما خلقت الآلهة البشر فرضت عليها
الموت ,
واحتكروا الحياة في أيديهم
وأنت يا جلجامش اجعل بطنك مملوءة
وكن فرحا ً ليلا ً ونهارا ً واعمل طربا ً في
كل يوم
رقصا ً ولعبا ً ليلا ً ونهارا ً ولتكن ملابسك
نظيفة ,
ليكن رأسك مغسولا ً ولتستحم بالماء }
فالإنسان القديم أكتسب خبرته من الحياة , ومن الصعوبات التي كان يعانيها , مما دفعه إلى خلق رموزه , وفنه , ورؤيته للحياة , من باب الدفاع عن الوجود , لذا نرى أن رؤية كاتب الملحمة ومؤلفها , أراد تحقيق , مفردات البنية التحتية للوعي عند الإنسان البسيط , عبر رعايا أوروك , وبذلك حقق انحيازه إليها مبدئيا ً, وهذا ما نراه متحققا ً في فصول الملحمة , حتى تغيـّرت رؤية ( جلجامش ) لحقيقة وجوده ومكانته الاجتماعية , أي بما يكسبه من تأييد شعبي ,وقد تركز ذلك في إصراره على الإكثار من عشبه الخلود بواسطة زرعها ومن إشاعة استخدامها , كي تشمل كل شيـَبة أوروك . حيث تجسدت هذه الأفكار الشعبية في جملة طقوس دالة , لعل الأحلام واحدة منها . فالأحلام التي راودت الملك , وهي في مجملها أضغاث أحلام , دافعها ومستنبتها السلوك اليومي الخاطئ . أو هي بدافع الشعور بالذنب , لذا فهي استجابة للاوعي , كما أكدته ننسون وهي تجري تفسيرا ً لها . وهو في مجملها تفسيرات تحاثث الوعي الشعبي . وهي أي ــ الأحلام ــ تـُبوب على أساس اللاوعي في عقل الإنسان , أو الخزين غير الواجد مجاله في الواقع , فتكون الأحلام خير ما تبشر عنه , وتثير عليه التساؤلات . ولعل التفسيرات التي قدمتها الأم( ننسون) , تندرج في مجال التفسير الشعبي أيضا ً , في البحث عن القرين المادي والشخصي كدلالة على المعنى المرتقب , والمراد فيه تغيير بنية الملك , الذي يتوجب أن يكون مطابقة لرؤية الواقع حيث احتوت على إشارات تحذيرية للملك من مغبة التمادي في غيـّه . يبقى الدليل الأخير على اعتبار الملحمة نصا ً شعبيا ً , هو قدسية الرقم سبعة , فهو يتطابق مع المفهوم المثيولوجي في الأديان والأساطير , في كونه ذو دلالة كونية , في خلق الكون . والذي أنسحب إلى مجمل الطقوس الشعبية , فاكتسب قدسيته من دلالته في كل حيز مكاني وزماني . ثم طقس حزن جلجامش على موت أنكيدو , فقد كان عبر قص شعر الرأس , واختيار لازمة لمندوبة خاصة , يرددها بالقرب من جثمانه , ولسبعة أيام .
هذه الدلالات وغيرها , تضع الملحمة في مصاف النصوص ذات الصلة المباشرة بمجموع الناس , في كل زمان ومكان , وهي جزء من ثافتهم الشعبية . وأعتقد أنها وغيرها أيضا ً ساهمت في ظاهرة تداولها عبر كل العصور والأزمنة لأنها اكتسبت صلتها بالقاع الحياتي , من مدلولها الشعبي الخالص . ولنر مستوى الطقسية التي أتت عليها مفاصـــل الملحمة .
فعند طقس استمالة ( شمخت ) لــ (أنكيدو) , كانت العبارات التي رددها النص كالآتي :
{ كشفت شمخت المحظية عن صدرها
وكشفت جسمها العاري , وتملك الوحش مفاتنها
خلعت ملابسها واستلقى عليها
وجعلته يمارس عمل المرأة
وضغط صدره بقوة على ظهرها
وبقي انكيدو مواصلا ًالمحظية شمخت لستة ايام وسبع ليال }
هذه الشعيرة كشفت عن الطقس الجنسي , الذي هو دالة على توصل معرفي للطرف الوافد إلى الحاضرة . وشمخت من هيئ لمثل هذا الطقس الشعبي الذي هو جزء من الزواج المقدس , متمثلا ً في ( الطقس المقدس ) . أما بصدد التغيير الذي حدث في حاضرة أوروك , فأنه أيضا ً تمثل الطقسية الشعبية حيث أشارت الملحمة إلى ذلك لتأكيد شعبيتها كما هو واضح في مثل :
{ حيث صار كل يوم عيدا ً
حيث الناس يتلألئون بملابس العيد
حيث الصبيات في العيد
والمحظيات ….
الفاتنات المزوقات الممتلئات بهجة }
هذا الوصف يبدو خالص الدقة في عكس مباهج رعايا أوروك , بعد أن شهدوا انفراجا ًفي سياسة الملك .
أما بصدد الأحلام , باعتبارها أُمنيات مؤجلة , يخزنها العقل الباطن , فأنها تشي بمدلولات إيجابية ساهمت في رسم الصورة الصحيحة لسلوك الملك جلجامش , على اعتبارها مؤشرات لمفاهيم كفيلة بتغيير الحياة , ولأنها لصيقة بأحلام الرعايا أصلا ً . مما يضيف إيجابية لورود هذه الأحلام في الملحمة فمثلا ً كانت ( ننسون ) تفسّر الحلم أمام ولدها , لكي تمنحه التوازن النفسي . بمعنى تعالج العقدة التي أسست أفق القلق الذي ينتابه . ودليل هذا تعلقه بالتفسير , ومن ثم بلقاء أنكيدو .
{ نينسون الحكيمة العارفة كل شيء , قالت لجلجامش
إن الفأس التي رأيت هو رجل
وأنت انحنيت عليه كأنه امرأة
وجعلته الرفيع المعادل لك
هو الرفيق القوي الذي ينقذ الصديق }
في هذا نجد مرميين , هما : توفر الحلم على أنه طقس له علاقة بالمفهوم الشعبي كذلك دلالته لخلق التوازن عبر التفسير أي أن هنالك هدفا ً سيا ــ اجتماعي , يتركز في إحداث نوع من الموازنة النفسية . غير أن كل ذلك مرتبط بالطقسية التي يمارسها الإنسان , والتي تطرح مفاهيم ورؤية اجتماعية شعبية . وهذا ما يشمل كل أحلام جلجامش , والتي تكشفت أمام الأم ننسون , فكان التفسير إضافة نوعية بصّرت جلجامش الذي أمتلك استعدادا ً للتغيير . أما الحلم الذي سرده لأنكيدو وهم في طريقهم إلى غابة الأرز , فقد كان دالا ً على القلق والخوف والتوجس من الدخول إلى الغامض والمحذور :
{ يا صديقي الم تنادني ؟ لماذا أجلستني من النوم ؟
الم تلمسني ؟ لماذا أنا خائف جدا ً ؟
هلا مر إله ؟ لماذا خدر جلدي ؟
يا صديقي لقد رأيت حلما ً ثالثا ً
وكان جميع الحلم الذي رأيته مخيفا ً
( فقد ) أرعدت السماء ( و ) استجابت لها الأرض
وتلاشى النهار وحلت الظلمة
ومض البرق واشتعلت النار
( و ) امتلأت السحب وأمطرت موتا ً
وخف التوهج وخمدت النار
وتحول جميع ما وقع رمادا ً }
إن كل ما ورد دليل دقيق على البنية النفسية التي عليها ( جلجامش ) , وما موقف أنكيدو , سوى إبعاد مثل هذا الشك من ذهن الملك . بمعنى كان التفسير محايثا ً للوعي الشعبي الذي يوازن بين الأشياء , ويضع المتماثلات التي من شأنها إحداث الاستقرار في الموقف الصعب . إن رؤيا جلجامش كانت دوافعها أفعال في الواقع , ورغبة كامنة في التغيير , لم يتمكن من التعبير عنها , لذا كان الأحلام ذريعة أو قناعا ً مكنه من استقبال حياة جديدو مغايرة , وما إسهامه ننسون إلا ً دليل فهم جيد لبنية ولدها المبنية على القلق والخوف من مصير مجهول . والدليل على ذلك استجابته لأنكيدو , وعقده صفقة المرافقة إلى غابة الأرز . كذلك دفعه لشمخت للذهاب إلى أنكيدو وترويضه واصطحابه إلى الحاضرة .
وحين أوشكت رحلة جلجامش على البدء إلى غابة الأرز , فأن الأم ( ننسون ) أعدت لأنكيدو طقسا ً , أملت من خلاله وصاياها له وهو يزمع مرافقة ولدها كدليل وحامي لخطى وأحلام الملك . وهذا الطقس تمثل بجملة فعاليات القصد منها إعطاء أهمية احتفالية لشخص أنكيدو , كما وأنها خاطبته بعبارة ولدي , تحقيقا ً للأمومة بالتبني والدال على نوع من الاعتزاز بشخصه , ورغبتها في حماية ولدها من التمادي في غيـّه من جهة , ومن حمايته من ألأذى الذي قد يلحق فيه جرّاء رحلة الغموض هذه :
{ قدمت البخور وتلفظت التعويذة
ودعت أنكيدو وقدمت له وصية
يا أنكيدو القوي أنت لست من نسلي
أقول لك الآن مع أنصار جلجامش
الكاهنات العلويات والمنذورات وفتيات
الطقس ,
ووضعت مسندا ً على رقبة أنكيدو
وأخذت الكاهنات العلويات
وعظموا زوجات الأرباب }
وفي مكان آخر مارست نفس الطقوس الدالة على مفاهيم شعبية خالصة , وهي تشبه المراسيم التي تقيمها النساء درءا ً للسحر ودفع الخطر المحتمل الذي يداهم الأعزاء ممن يرتبطن بهم :
{ دخلت ننسون إلى غرفتها ولبست
بدلة ملائمة لجسمها
ولبست حليا ً تلائم صدرها .. ولبست
غطاء رأسها
صعدت السلم واعتلت الحاجز
أوقفت السقف ووضعت البخور إلى
إلى الإله شمش
ووضعت السكيبة أمام الإله شمش ورفعت
يديها .. }
كما ونلاحظ أن أنكيدو مارس نفس الطقوس, وهو يستعد لفعل ما , فكان الوصف كالآتي :
{ دهن أعضاء جسمه ومسح نفسه بالزيت
وصار كإنسان
فارتدى بدلة وصار مثل الرجال
وأخذ سلاحه ليقاتل }
ولعل حزن جلجامش , قد توج الطقسية الشعبية في الملحمة , وهو حزن يتخلله رثاء ومندوبة ذات صفة شعبية . وهي مراسيم عراقية استنبتت منذ عصر السومريين ــ كما ذكر الدكتور نائل حنون في كتابه / عقائد ما بعد الموت في وادي الرافدين / ــ . وما استجابة جلجامش لهذا الطقس أو الشعيرة , سوى إظهاره لمدى حزنه جرّاء فراقه الأبدي لخلـّه أنكيدو :
{ إسمعوا يا شيبة ( اوروك ) إستمعوا لي
إني أبكي على صديقي انكيدو
أبكي ( عليه ) بصوت عال كامرأة منتحبة
( إنه ) الفاس التي ( على ) جانبي والقوس ( الذي ) في يدي
وهو السيف ( الذي في ) حزامي , والدرع ( الذي ) أمامي
وبدله أعيادي وزينتي الثرية
أخذه مني عفريت شرير
صديقي الشاب الذي كان يصطاد حمار وحش التلال وفهد البرية
صديقي الحدث السن أنكيدو
اصطدت حمار وحش التلال وفهد البرية
الذي امسك وذبح الثور
وذبحنا خمبابا الذي يعيش في غابة الأرز
فماذا دهاك الآن ؟ هل هو النوم قد تمكن منك ؟
هل دهاك الظلام ؟ أفلا تسمعني ؟
لمس جلجامش قلبه ( فوجده ) لا ينبض
فغطى وجهه مثل ( ما تغطي ) العروس
وصاح عاليا ً مثل أسد ولبوه فقدت أشبالها
وصار يروح ويغدو أمام ( صديقه )
……… ناتفا ً ( شعره ) وراميا ً ( له ) بعيدا ً
ممزقا ً ثيابه وكأنها غير نظيفة
وعند بدء الصباح في الإنارة , }
هذه المندوبة تكشف عن مدى القلق الذي اجتاح جلجامش , الذي سببه حزنه على فقدانه الأزلي لخله أنكيدو , متوسلا ً بكل التقدميات التي قدمها إليه في حياته , دليل تعلقه بشخصه , مما حدا فيه إلى تذكر كل تفاصيل العلاقة . وهذا نوع وشكل من التعزية التي تؤديها الذات مع نفسها , اعتزازا ً بالفقيد , كما هو في الموروث الشعبي , أو الثقافة السائدة بين الناس في أحزانهم وأفراحهم , معبّرين عن درجة التعلق بالآخر . حيث نرى جلجامش يـُكثر من ذكر مثل هذه الشواهد الدالة على العلاقة بينه وبين أنكيدو في :
{ جعلتك ترقد في سرير نبيل
أجلستك على كرسي الراحة , المكان الذي على اليسار
حتى يقبل أمراء الأرض قدميك
سأجعل أهل اوروك يبكونك ويحزنون عليك
وسأملأ السعداء من الناس حزنا ً عليك
وأنا من بعدك سوف أترك شعر جسمي دون قص
وألبس جلد الأسد وأجوب البرية }
وإزاء هذا الشعور بالمرارة والحزن على الفقدان , نراه يرثي نفسه , مجسدا ً خوفه من الموت , والمصير المحتوم الذي يتهدده :
{ على صديقه أنكيدو يبكي جلجامش بمرارة , ويجوب البراري
عندما أموت , هل سوف لا أكون مثل أنكيدو ؟
لقد دخلت الأحزان فؤادي
أنا أخاف الموت ( ولهذا ) أجوب البراري }
يتجسد حزنه أكثر وهو يطلق مندوبته على جثمان صديقه :
{ الذي ذهب معي ( في ) جميع الصعاب
أنكيدو الذي أحببت كثيرا ً وذهب معي في جميع الصعاب
قد ذهب إلى مصير البشرية , وبكيت عليه ليلا ً ونهارا ً
وسوف لا أعطيه إلى القبر
( هل ) أن صديقي لا يستيقظ على نحيبي
سبعة أيام وسبع ليال , حتى سقطت دودة من أنفه
ومنذ فراقه لم أجد أي حياة وهمت في البرّية كالصياد . }
ومن أشكال الطقسية التي أشرت محتوى صياغة الذهن الشعبي في الملحمة , ما ذكره الدكتور ( سامي سليمان الأحمد في كتابه ( جلجامش ) , ما مفاده “وقد وضعوا أشكالا ً طينية لجلجامش , وضعوها على مداخل البيوت لحمايتها من أرواح الشرور ص67 . كذلك نلاحظ أن الملحمة تشير إلى الذهنية الشعبية التي تحيل التشكل الأول إلى الطين , مثلها مثل قصة الخليقة البابلية , وبمثل ما قامت فيه ( أورورو ) وهي تخلق أنكيدو من الطين . إن العودة إلى الخلق الأول بدلالة العودة إلى الطين , دليل على ما اعتمدته الذهنية الشعبية وهي تصوغ أكبر ملحمة , روت حكاية الرعايا المسحوقين في أوروك . إذ نرى جلجامش يؤكد على مثل هذه العودة في :
{ حقا ً لقد رجعت الأيام الأولى إلى طين }
وفي مكان آخر يذكر :
{ صديقي الذي أهيم من أجله في البرية , البعيد , مسألة انكيدو صديقي
طرق بعيدة أجوبها في البرّية
كيف اسكت ؟ كيف أتكلم ؟
صديقي الذي أ ُحب تحول إلى طين }
لنخلص مما تقدم إلى ؛ إن نص الملحمة , هو نص معني بثقافة الناس الشعبية ومتشكل محتوى ذهنهم الشعبي , الذي يؤسس وعيهم الطبقي , لأن الملحمة في هذا عالجت همومهم الحياتية , وما سببته السلطة الحاكمة من إرباك لها , ثم أن آليات طرحهم لمثل هذه الإشكالات في الحياة , تجسد في صراع غير حاد مع بنية الملك السياسية ــ الاجتماعية حيث توسلوا جرّائه بنوع من الطقسية أيضا ً , وهو التضرع إلى الإله شمش في إنقاذهم مما هم عليه من حال . وكان ذلك مجسدا ً بجملة فعاليات ذات خاصية شعبية , لأنها تـُخاطر وتتماثل مع مكون الرعايا في أوروك .
———————————————————— jassimasee@yahoo.com
هامــش /
اعتمدت القراءة أعلاه على ترجمة الملحمة , للدكتور سامي سعيد الأحمد تحت عنوان ( جلجامش ) / من إصدار دار الشؤون الثقافية العامة ــ بغداد عام
ا