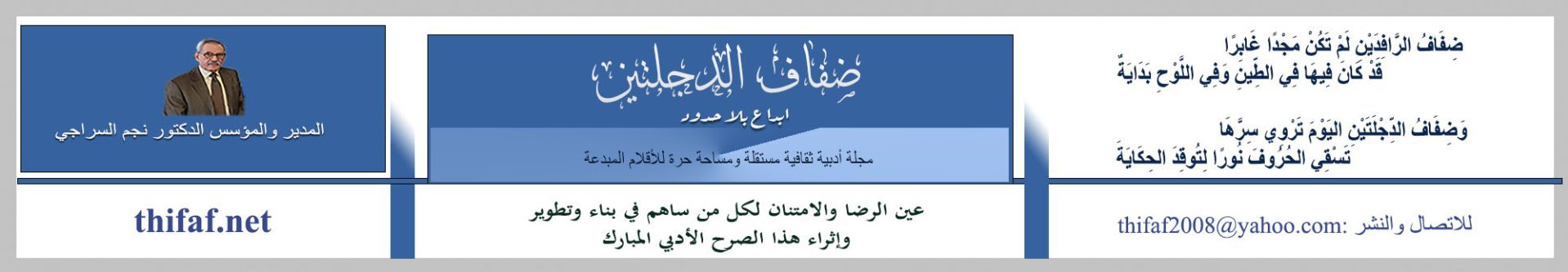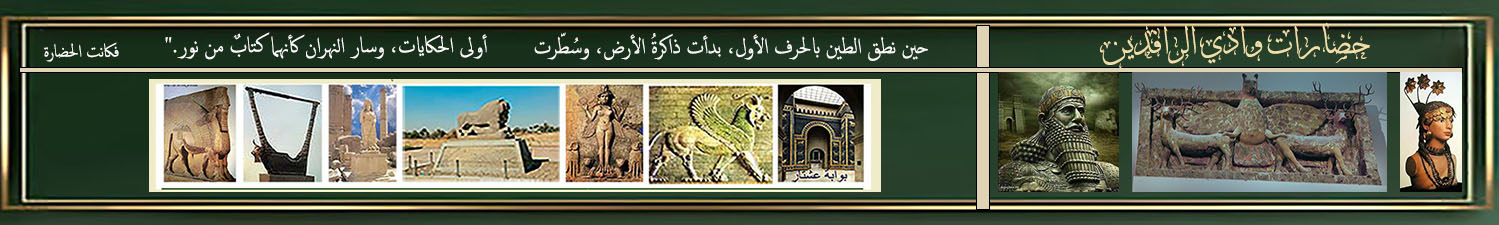إدريس كثير
فـــي جمــاليــــة البينـونـــة(ß)
إدريس كثير
منذ البداية يعلن الناقد رشيد بنحدو أن ملفوظ “البين – بين” أو “الما بين” أو مفهوم “البينونة” انبثق لديه “من غير سبق تدبير وتصميم”(ß). وهذا أمر يبعده عن التعسف أو التمحل الذي يأتي بالملفوظ أو المفهوم البراني ليفرضه فرضا على النصوص وعلى جوانيتها: (كما هو راجح للأسف في الوعي النقدي السائد عندنا).
للملفوظ “البين – بين” قوة تداولية وجمالية، وللمفهوم ذاته قوة مفهومية فلسفية.
من الاستعمال في الحياة اليومية:
البين بين هو التردد في قيمة شيء ما بين الرديء والجيد
- التحديد التقريبي للزمن بين 7و8.
- التعبير غير الدقيق لمكان ما بين محطة القطار ومحطة الحافلة.
- لوصف المأزق: بين المطرقة والسندان بين الحياة والموت.
- للتحرك الفضائي بين فاس ومكناس.
- للتحديد الوجودي بين الطفولة والشيخوخة بين المهد واللحد..
- للخطاب الديبلوماسي بين الدهاء والمرونة.
- للغربة والاندماج بين الوطن واللاوطن.
- للترجمة والتذبذب بين لغة وأخرى.
- للحيرة والالتباس…
إلى التشقيق اللغوي:
كلمة “بين” ظرف يفيد وسط شيئين، وهي من الأضداد تفيد الفرقة والوصل في آن واحد، كالجون الذي يفيد الأبيض والأسود. ولربما هنا تكمن قوة المفهوم!
إلى القوة الكشفية: (البين بين)
سيكولوجيا: هو بين إروس و/طناطوس بين قتل الأب و/الزواج بالأم. بين الإبصار والعمى..
سوسيولوجيا: بين المركز والهامش وبين الشغل والاستلاب، وبين المدينة والبادية.
أنثروبولوجيا: المثاقفة/ أو المابين الثقافي هو بَوْن بين الطبيعة والثقافة/ بين الأصالة والمعاصرة..
لسانيا: البيلغة هي /فيما بين الدال/ والمدلول، الكتابة والاختلاف/ الصوتي والغيرية: “أو الأنا الذي ليس هو أنا”.
ومن هذا الكشف إلى القوة الجمالية:
لا تنحصر هذه القوة الإستطيقية في الإبداع الأدبي وجنسه الروائي؛ ولا في النقد الأدبي فقط وإنما تتجاوزهما إلى الفن عامة والفن التشكيلي على الخصوص.
– لقد انتقلت النظرية الأدبية من النص إلى هوامشه ومن المؤلف إلى القارئ ومن القراءة إلى الكتابة، ومن القصة إلى الحكي ومنه إلى السرد… وتداخلت النصوص في النص الواحد وتناصت، وأصبح النص (الأدبي) بين المطلع والمقطع، وأضيفت إلى النص زوائد:
Hypertexte, Architexte, Paratexte أو ألحقت به لواحق Texto, Texture, Textualité.. وتراوح النص بين المركزية الصوتية phonocentrisme وبين المركزية الذكورية Phallocentrisme… كل هذه التحولات كانت بحثا عن الخروج من “التكرار والجمود إلى المغامرة والتجريب“، والمروق من “الثبات والفسولة” عبر القفز إلى “هروب المعنى” والتباسه. لذا لا يهتم الناقد رشيد بنحدو بتأرجح النصوص بين كذا… وكذا فهذا التأرجح مثنوي مانوي (بين الخير والشر أو النور والظلام) بل يهتم بالنصوص وهي تتفاعل أي كما يقول “بالمعنى وهو يتشكل وليس أياه وقد نشكل”. وهذه هي الاندلالية (Signifiance) في قوة بينونتها بين الدال والمدلول، وبين هذا الأخير والإحالة، لتؤلف نسيجا (Texture) وتسبك لغة وتثقن ترصيفا.
العودة إلى رولان بارث أو البنيوية أو الشكلانية أو التفكيكية لا تخلق ناقدا.. دينا صورا إنما تشعرنا بالتاخر السريع في إجرائية النقد السائد لدينا بين ما وصلوا إليه وما نحن فيه بين بائن. يكفي العودة إلى “درس”(ß) رولان بارث وحديثه عن سلطة أو تسلط اللغة لمعرفة أن ما يحررنا من تلك القبضة الحريرية هو الأدب (والرواية على الخصوص)، والأدب لدى بارث هو آثار وممارسة: أي ممارسة الكتابة وممارسة النص (نسيج دوال تُكون العمل الأدبي)، هذا النسيج اللغوي هو الذي يخلصنا من السلطة (بما فيه سلطة اللغة) ذلك أن بين اللغة واللغة هناك اللعب واللهو والغواية والهواية.. هذا المرح والزهو ليس عتيقا عقيما إنما هو حداثي عميق.
قوة البينونة الجمالية نلمسها في الفن أيضا فأكبر اللوحات الفنية يحكمها منطق المابين – بين. وجه الجوكاندا يتراوح بين الابتسامة والألم، بين الذكورة والأنوثة، وأوديب ف. بيكون يترنح بين العطب والعمى وبين المحارم والمكارم، وغيرنيكا بيكاسو ترزح تحت بينية الحرب والسلم والبشاعة والجمال وهلمجرا. التباس البينونة هو الجمال!
إن الذي يمكنه أن يفسر لنا عمق هذه الجمالية هو هيجل(ß1) في حديثه عن “العظيم أو المتعالي” (Le sublime). يقول: “العظيم عامة هو محاولة التعبير عن اللانهائي دون العثور على الموضوع القادر على تمثيله في مجال المظاهر، (ص470). نملك فكرة عن الكون لكن لا نستطيع تجسيدها ونمك فكرة عن البسيط لكن لا نستطيع تمثيلها. بين الموضوع والمفهوم تبرز جمالية البين-بين. أمام هذا الإحراج بين فكرة “اللانهائي” وبين الموضوع الظاهراتي.. يبزغ الجمال خاصة حين يتوفق –إلى حد ما- الفنان المبدع في التعبير عما لا يمكن التعبير عنه. هذه الجمالية تغدو أكثر انسجاما ورونقا حين تتوطد بمفهوم البينونة، هذا الأخير غير مأخوذ ولا مستعار بالضرورة عن لغة أخرى (فرنسية كانت أو إنجليزية). إنما هو مفهوم عربي قُح. ولتعليل قولنا نضرب بيدنا إلى أبي حيان التوحيدي فهو يقول: “… تحديد الأخلاق لا يصح إلا بضرب من التجوز والتسمح، وذلك أنها متلابسة تلابسا ومتداخلة تداحلا، والشيء لا يتميز عن غيره إلا ببينونة واقعة تظهر للحس اللطيف، أو تتضح للعقل الشريف” (ص128) جIII). (ß2)
واضح أن أبا حيان التوحيدي يؤسس البينونة هنا على: التجوز والتسمح على الملابسة والتلابس والتداخل والمتداخل لأجل التمييز والفرز.. خاصة في موضوع القيم، أي الأخلاق/ أما رشيد بنحدو فيؤسسها في مجال الأدب.
فالأخلاق حسب التوحيدي تحتاج وتتوقف على “البينونة” لأن الإنسان يوجد بين العقل والحمق والعلم والجهل والحلم والسخف والقناعة والشره والحياء والقحة والرحمة والقسوة والأمانة والخيانة والتيقظ والغفلة والتقى والفجور والجرأة والجبن والتواضع والكبر والوفاء والغدر والتضحية والغش والصدق والكذب والسخاء والبخل والعدل والجور والحقد والصفح… إلخ.
كما يجد الروائي نفسه حسب رشيد بنحدو بين النص واللانص وبين الأنا وغير الأنا وبين الماضي والمضارع وبين هذيان الكتابة وكتابة الهذيان وبين الطرس والطمس والكابوس والكاووس والهنا والهناك…
جمالية البين – بين ومفهوم البينونة يتأسسان بدورهما على منطق دقيق قلما ننتبه إليه؛ هو منطق المفارقة (Paradoxe). وهذه الأخيرة من حيث التشقيق اللغوي هي الرأي والرأى الموازي؛ هي السير في طريقتين في آن واحد هي التحرك فيما بين خطين متوازيين، وهي في مستوى المنطق ليست تجاوزا للتناقض فقط بل هي أيضا تجاوز للحس المشترك (Le sens Commun) وللحس السليم الساذج (Le bon sens). لنضرب مثالا على ذلك “بمفارقة مينون” حول المعرفة كما صاغها “أفلاطون”(ß): إذا كنت أبحث عن شيء لا أعرفه ما السبيل إلى معرفته؟ وإذا عثرت عليه فكيف أعرف أنه هو الذي كنت أبحث عنه؟ وإذا كنت أعرفه فما الداعي إلى البحث عنه؟
فالأمر هنا لا يتعلق بالانتقال بين المعرفة واللامعرفة؛ بقدر ما يتصل باستحالة المعرفة أو على الأقل بالتباسها وتضاربها، ضدا على الحس المشترك وسذاجة الحس السليم/ هذه الاستحالة والالتباس يصوغها سقراط على الشكل التالي:
لا يمكن للإنسان أن يبحث لا فيما يعرفه ولا فيما لا يعرفه: ذلك لأن ما يعرفه لا يبحث فيه لأنه يعرفه، وما لا يعرفه لا يبحث فيه لأنه لا يعرف عما سيبحث عنه.
المفارقة المنطقية هذه هي صعوبة السير في هذا الاتجاه أو في ذلك. أما مفارقة جمالية البينونة فهي السير فيما بين الاتجاهين./ تعلمون أن le sens في اللغة الفرنسية لا يعني الاتجاه فقط إنما يعني المعنى أيضا، فالبينونة لا تكتفي بالوقوف على المعنى بل تتعداه إلى فهم اللامعنى باعتباره اتجاها ووجهة من وجهات وأوجه المعنى/ لا يبدعه الأديب إنما يبدعه الناقد.
لذا اختم قولي بما ختم به بنحدو قوله: “مرة أخرى هل أكون/كنت (بين المضارع والماضي) إذن في مستوى ما يتطلبه التحليل النصي لجمالية البين –بين من جدة وابتكار؟ هل يكون ارتواء متخيل النصوص الروائية التي تفانيت في اختصاصها، بمتخيلي الشخصي قد كيف خطابي النقدي على نحو يجعله متسما ببعض الطرافة والقراءة؟” (ص377).
ß– رشيد بنحدو. جمالية البين – بين في الرواية العربية. منشورات مؤسسة نادي الكتاب بالمغرب. 2011.
ß– ويقول: ص15 “إن اهتمامي القديم بفكرة “البين – بين” هو ثمرة مصادفات لا أثر فيها لتدبير مسبق” وأيضا قوله: “من غير سبق ترصد أو تعمد” (ص29) فكأن “البين – بين” يزاول فيها (أي النصوص) مفعوله بالمصادفة”. وأيضا: “لقد انتبهت… إلى أنني كنت أكتفي بإبراز تجليات هذه النزعة المابينية في النصوص المدروسة وفحص آثارها وتأويل رهاناتها دون اهتمام بتأطيرها”
ß– Roland Barthe – leçon, édition Seuil. 1978 P:
1ß – Hegel/ Esthétique,tr.charles benard. livre de poche, 1995/1997, P470.
ß2 – أبو حيان التوحيدي -الإمتاع والمؤانسة- منشورات دار مكتبة الحياة.
ß – Platon. Ménon. Tr. Monique canto- sperber. Flammarion.